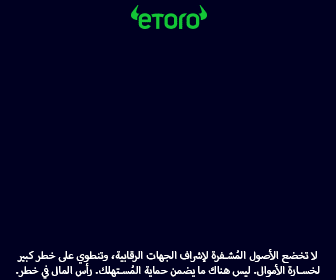يقال إن السياسات بكافة أنواعها محلية، لكن هل ينطبق هذا على الاقتصاد؟ في الماضي، لم يكن الحال كذلك كليةً، أما اليوم فقد بات التباين أوسع فأوسع.
توجهات اقتصادية متباينة
دعونا نعود بذاكرتنا إلى التسعينات وبداية الألفية، حين بلغت العولمة أوجها في عالم أحادي القطب تهمين عليه القوة الاقتصادية والجيوسياسية الأميركية. حينذاك كانت أسواق الأسهم حول العالم تسير على إيقاع وول ستريت، والبنوك المركزية تضع سياساتها تماشياً مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، تفادياً للعواقب إذ كانت الأموال الساخنة تتدفق إما لتدخل سوقاً أو لتخرج منها، وكان في ذلك تهديد لاستقرار العملات والأسعار.
استفاد حلفاء الولايات المتحدة من إتاحة الأسواق والاستثمارات والتقنيات الأميركية، وجلب ذلك لهم ازدهاراً. أما خصومها فعانوا من العقوبات ومن تقييد الصادرات، فعاشت تلك الدول عزلةً وتخلفاً تقنياً وفقراً. ولعلّ أفضل مثال على ذلك هو التباين بين مصير الاتحاد السوفياتي، خصم أميركا الذي انهار، والصين التي حققت ازدهاراً حين كانت صديقة لأميركا.
لنتأمل الوضع الحالي بالمقابل، إذ تسير معظم الاقتصادات الكبرى في اتجاهات متباينة. كانت المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة خلال السنتين الأخيرتين هي تسارع التضخم في حقبة ما بعد الوباء، وهي مشكلة طالت أوروبا أيضاً، وتفاقمت إثر الحرب في أوكرانيا التي ترافقت مع وقف إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
في المقابل، كان ارتفاع التضخم في اليابان أمراً إيجابياً، ومؤشراً إلى انتعاش اقتصادها الذي يعاني من الركود. أمّا في الصين، فالمشكلة لم تكن بارتفاع الأسعار، بل انخفاضها.
بالتالي، تتباين وتيرة حركة بنوك مركزية عدة، بل إن اتجاهاتها تتباين، فقد تأخر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة عندما ارتفع التضخم، ثم تأخر في خفضها مع تراجع التضخم. من جانب آخر، سبق كلّ من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، وهو ما فعلته أيضاً بنوك مركزية كثيرة في الأسواق الناشئة.
وفي الصين، تعمل السلطات على كبح انهيار بطيء لسوق العقارات، وعلى دعم سوق الأسهم. أمّا بنك اليابان، فلا يعتزم خفض أسعار الفائدة، بل رفعها.
تراجع الهيمنة الأميركية
عندما تسير البنوك المركزية في اتجاهات مختلفة، تحصل أمور غريبة. فلنأخذ على سبيل المثال ما حصل مع الين الياباني في الآونة الأخيرة، فقد تراجعت قيمة العملة اليابانية خلال النصف الأول من العام، ثم ارتفعت في الصيف، لتعود وتنخفض مجدداً في ظلّ التباين بين توقعات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
لا تخلو تقلبات أسعار العملات من العواقب، فضعف الينّ أسهم في زيادة أرباح الشركات اليابانية وانتعاش مؤشر نيكاي. ولكن إثر ارتفاعه، انقلب الوضع، ما أسفر عن تراجع الأسهم اليابانية بنسبة 12% خلال يوم واحد في أغسطس.
كانت التجارة المبنية على فارق تكلفة الاقتراض في اليابان، التي تقدر قيمتها بنحو 4 تريليونات ين، قوة دفع، إذ يقترض المستثمرون بكلفة منخفضة في اليابان، ويستثمرون في أصول ذات عوائد مرتفعة في أماكن أخرى. لكن مع ارتفاع قيمة الين، لم تعد هذه الرهانات مربحة، فتخلى عنها المستثمرون بسرعة فائقة، موجهين ضربة لكل شيء، من الأسهم الأميركية إلى البيزو المكسيكي وحتى عملة بتكوين المشفرة.
ليس الاحتياطي الفيدرالي المؤسسة الكبرى الوحيدة في واشنطن التي أخذ نفوذها العالمي يتراجع. فلننظر إلى السياسة الأميركية تجاه روسيا على سبيل المثال. فرضت إدارة جو بايدن في 2022 حزمة واسعة من العقوبات على موسكو كانت تهدف إلى شل اقتصاد حرب الرئيس فلاديمير بوتين.
لكن مشتريات الهند من النفط أبقت خزائن موسكو ممتلئة، فيما صمد القطاع الصناعي الروسي بفضل الصادرات الروسية، واستمرت مدفعيات بوتين بإطلاق نيرانها بفضل ذخائر المدفعية الكورية الشمالية. نتيجة لذلك، تتجه روسيا في 2024 لتحقيق نمو بنسبة 3.5%، فيما تواصل قواتها التقدم في أوكرانيا.
ما الذي يحدث؟ أولاً، تغيرت بنية الاقتصاد العالمي، وباتت حصة الولايات المتحدة وحلفائها فيه أصغر. في عام 1990، كانت الولايات المتحدة وحدها مصدر 21% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، فيما كان يأتي نصفه من دول مجموعة السبع. لكن بحلول 2024، تراجعت هذه النسب إلى 15% و30% على التوالي.
تنامي دور اقتصادات أخرى
ثانياً، بدأت أنحاء واسعة من العالم تبتعد عن نموذج العمل الذي صممته الولايات المتحدة. في الماضي، كانت دول مجموعة السبع تتخذ القرارات الكبرى، ثمّ مع صعود الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، توسع هذا النادي إلى مجموعة العشرين. إلا أن الخلافات العميقة بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى أفقدت المجموعة كثيراً من فعاليتها.
وكان من علامات هذا التراجع ظهور تكتلات منافسة، مثل مجموعة البريكس التي بدأت كمجموعة استثمارية تحولت لاحقاً إلى ناد فعلي، يضمّ البرازيل وروسيا وغيرها من الأسواق الناشئة التي تستضيف قمم المجموعة بالتناوب.
ورغم أن الدولار ما يزال العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم، إلا أن هيمنته تراجعت. فقد انخفضت حصته من احتياطيات البنوك المركزية العالمية من 72% في عام 2000 إلى 58% في عام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وتشير بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن الصين تسوّي الآن ربع تعاملاتها التجارية باليوان، بعدما كانت النسبة صفراً قبل نحو عقد.
لا عجب إذاً من تراجع جاذبية الولايات المتحدة مع تنامي نفوذ الاقتصادات الأخرى، بالأخص الاقتصاد الصيني. في الأشهر المقبلة، ستظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة وحجم خفض أسعار الفائدة مهمة، ولكن برنامج التحفيز الذي تنفذه بكين سيتجاوزه أهمية على الأرجح. إذ يشير نموذج أعدته بلومبرغ إكونوميكس إلى أن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أواخر سبتمبر، ستضيف حوالي 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام المقبل، وربما أكثر بكثير إن أوفت وزارة المالية الصينية بتعهداتها بشأن التحفيز المالي.
وهذه كلها أمور تكتسب أهمية سواء بالنسبة للحكومات التي تكافح للحفاظ على نمو اقتصاداتها، أو الشركات التي تسعى لضمان استمرارية سلاسل التوريد، أو المستثمرين الباحثين عن زيادة العوائد.
فرص ومخاطر
في عالم يغنّي فيه كل اقتصاد محلي على ليلاه، ينبغي لقادة الأعمال توخي مزيد من الحذر. فقراراتهم حول مصادر التوريد والأسواق المستهدفة تكتسب أهمية أعلى بكثير، لأنهم إن أصابوا، ستعمل سلاسل الإمداد بسلاسة وتنمو الإيرادات، أما إن أخطأوا، فقد تتعرض شركاتهم لارتفاع الرسوم الجمركية والعقوبات وتراجع الطلب.
يواجه المستثمرون التعقيدات عينها، ولكن تحقيق الربح أو تكبد الخسائر يحصل على نحو أسرع. خلال بضعة أسابيع فقط، شهدنا ارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني ثم تراجعه، فيما ابتعد بنك إنجلترا في سياساته عن الاحتياطي الفيدرالي. كما رأينا تعويض سوق الأسهم الصينية خسائر عام كامل في أيام معدودة بفضل تحفيزات المكتب السياسي، وارتفاع أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل لتصل إلى 80 دولاراً في بداية أكتوبر مع تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط وتوسعها.
أصبح الاقتصاد إذاً مسألة محلية. وإن استوعب المرء ذلك، فسيدرك أنه محاط بالفرص إذا عرف كيف يستغلها.